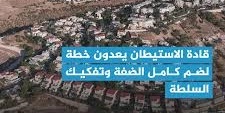عرض كتاب “الأمن كقضيّة مدنية”.. تعزيز الهويّة اليهوديّة يؤدي إلى انعدام الأمان الاجتماعي في إسرائيل
عرض وتعقيب: أحمد أشقر

اسم الكتاب: الأمن كقضيّة مدنية:
إضعاف الأمان المدني- السياسي- الثقافي في إسرائيل
المحررتان: (عيريت كينان) و(عيريت هربون)
إصدار: (برديس)، و(كليّة الإدارة)
سنة الإصدار: 2020
عدد الصفحات: 266 صفحة
اللغة: العبرية.
أسفرت انتخابات (الكنيست) التي جرت في الفاتح من شهر تشرين الثاني 2022 إلى تشكيل حكومة تعتمد بالأساس على القوى اليهودية الصهيونية، الفاشنازيّة- دون تحفظّ- وضعت نصب أعينها تعزيز الهويّة اليهوديّة و”الأمن” الذي هو تكثيف قمع العرب وضمّ الضفة الغربيّة بالكامل للكيان. لذا تعمل لتنفيذ انقلاب لإعادة توزيع مصادر الثروة، والحكم والسلطة مُمَثَلَة بأجهزة القضاء، والتربية والتعليم، والجيش والشرطة وحرس الحدود لصالح كل ما هو يهودي العقيدة والشريعة والتراث. ولتعزيز الهوية اليهودية رصدت الدولة مبلغ 8.1 مليار شيكل في ميزانية السنة القادمة (شاحر إيلان https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r146vrelh). أدى هذا الأمر إلى دخول الكيان في حلقة غير مسبوقة من الحلقات التي باتت تغطي كافة مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية والثقافية تتجلى بمظاهرات أسبوعية للشهر الخامس على التوالي يشارك فيها مئات الآلاف من الرافضين لإعادة توزيع الثروات التي نهبوها وراكموها على أنقاض وحساب وطن ودماء عرب فلسطين. تسبب هذا الانقلاب بحالة من عدم الاستقرار في الحكم والإدارة وانخفاض استجلاب الاستثمارات في المعلوماتيّة التي قوامها برامج التجسس العسكرية فائقة التدمير والقمع. إضافة إلى ما تقدم، باتت تداعيات الإنقلاب ملموسة على حياة الناس اليومية في الكيان، تجلّت برفع (بنك إسرائيل) نسبة الفائدة التي بلغت (4.75%) نهاية شهر نيسان الفائت، وارتفاع نسبة التضخم التي قد تصل إلى 4% نهاية 2023، مما أدى إلى رفع قيمة أقساط قروض الإسكان بـ800- 1500 شاقل شهريّا لتشكلّ عبئاً قاسياً لا تحتمله نسبة كبيرة من الأسر التي يبلغ عددها 600 ألف، وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع هذه القروض لمدة يبلغ مداها أحياناً 25 سنة. ولا تستثني دوامة الديون والقروض وسدادها أيّاً من الأسر (العربيّة واليهوديّة) في الكيان. كما تم رفع أسعار مشتقات الألبان والعديد من أنواع الأغذية والخدمات. وفي نفس الوقت، ارتفعت أرباح البنوك الخمسة الكبرى في الكيان بـ30%. إضافة إلى ما تقدم، بلغت تكلفة الإئتلاف الحكومي الحالي 13 مليار شيكل لليهود (الحريديم) حصة الأسد منه، ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الضرائب لسنة 2023- 24 بحوالي 15 مليار شاقلاً. أي أن تفاقم الأزمة سيتواصل حتى لو تم إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى، لأن المستفيدين من هذه الأزمة كُثُر.
وسرعان ما انعكس ما يجري في الكيان على العلاقات الخارجيّة التي تجلت بعدم دعوة النظام الأمريكي رئيس الحكومة (نتنياهو) إليها على العكس من العادة التي جرت بدعوة كل رئيس حكومة جديد، وكذلك قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء جلسته السنوية في الكيان كي لا يقوم الفاشنازي وزير الأمن القومي، (بن جفير) بإلقاء كلمة فيه مع تزايد الخلافات مع أطر ومنظمات يهودية عالميّة. أما المفارقة فهي قيام سفارة الإمارات الخلايجيّة في (تل- أبيب) باستقبال (بن جفير) في حفل رسمي لها في الأول من كانون الثاني سنة 2022. كما وشارك المغني الإماراتي، أحمد الحوسني، بحفل غنائي في الكيان احتفالاً بذكرى نكبة عرب فلسطين (ليس للنذالة حدود!). وفي احتفال يهوصهيوني في باريس، بتاريخ 28. 3. 2023، وقف الوزير الحالي (سموتريتش) على خلفيّة خارطة فلسطين والأردن، ليذكر ما نسي من العرب أن صكّ الإنتداب البريطاني كان على فلسطين وشرق الأردن (…). على ما يبدو هذه رسالة من الخلايجة إلى الدولة والنظام في الأردن.
يبحث الكتاب الذي بين أيدينا في سياسة انفصال عقد ثنائية الأمان (الاجتماعي) والأمن (العسكري) وسيطرته على حياة إسرائيل ومستعمريها، وكأنه جاء ليمهد لفهم ما يجري حاليّاً من صعود وتأثير القوى اليهودية الصهيونية و(الحريديّة) على مفاصل إدارة الدولة ومحاولة إعادة توزيع الثروات المادية والثقافية والسياسيّة مجدداً. والكتاب المذكور عبارة عن تسعة مقالات أعدها أكاديميون مختصون في الموضوع المطروح، ومقدمة وضعتها كلاً من (كينان) و(هربون) تقولان فيها إن حصر أية قضّية وجعلها أمنية فقط هو تأطير للمشكلة في مفاهيم استثنائية من أجل البقاء ومنح شرعية لتجاوز المفاهيم السياسية التقليدية القائمة (ص 9- 18). إضافة إلى هذه المقدمة أسهمت المحررتان بكتابة المقال الأول في الكتاب- “ساعة طوارئ مدنية: إضعاف الأمان المدني- السياسي في إسرائيل على ضوء متغيّرات اجتماعية تاريخية” تقولان فيه أن اغتيال (رابين) سنة 1996 دفع إلى الواجهة المركبات الدينية في الهوية الإسرائيلية وعزّزها نتيجة إعلاء شأن أرض إسرائيل الكاملة- مقابل تسوية ما مع العرب. كان هذا مقابل الأمان الاجتماعي الذي تميّز بما يسمى، “تحويل القضايا المدنيّة إلى أمنيّة في الهويّة اليهوديّة”. تم تحطيم مفاهيم وقيم الأمان مع وصول (نتنياهو) إلى السلطة سنة 2009 من خلال إجراءات عمليّة لجعل الأمن المركّب الأكبر في الهوية الإسرائيلية وتقليص العامل المدني فيها نتيجة إضعاف قوى المجتمع المدني في الدولة (ص 19- 50). يمكن القول إن استخدام الحجج الأمنيّة وتآكل القيّم المدنية التي هي الأخرى مشبعة بالعنصريّة اليهودية هدفت إلى ثلاثة أمور: الأول- إبعاد العرب عن الحياة السياسية في إسرائيل ومنع تأثيرهم عليها؛ والثاني- تعزيز مبدأ “السيادة الشعبية” التي طرحها أحد منظري الرايخ الثالث، (كارل شميدث/ 1889- 1985)، أي الزحف نحو سلطة الفرد الذي يحكم فوق القانون والقواعد المتبعة في الكيان [كنتُ قد نشرتُ مقالاً بعنوان “(كارل شميدث): ما بين كفر برعم 1951 و(أدلشطاين) 2020″، (أشقر، 2020)]؛ والثالث- منع أي ‘تعاون’ بين قوى يهودية ‘معتدلة’ والعرب. وهذا عمليّا ما تسعى إليه اليوم القوى الفاشنازية التشريعية- الحكومية.
في المقال الثاني- “العسكرة الجديدة للخطاب الأمني”، يقول (ياجيل ليفي) أن عسكرة جديدة للخطاب الأمني في إسرائيل تتطور منذ حوالي عقدين، وتتميز بثلاثة جوانب: الأول- استخدام القوة العسكرية التي تنفصل عن المنطق السياسي؛ والثاني- بحسب ليفي، “كان الجيش والمتقاعدين في الماضي هم الحامل الرئيسي للعسكرة، لكن العسكرة الجديدة في إسرائيل تتحملها بقوة أكبر القوى المدنية” مثل المُستوطنين، لذا باتت الحاجة في إدارة الأراضي المحتلة إلى الحجج اللاهوتية مثل قدسية الأرض و”الوعد الإلهي”، وبدرجة أقل على المنطق العسكري السياسي؛ والجانب الثالث للعسكرة الجديدة، بحسب ليفي، هو أن “نزع الصفة الإنسانية عن سكان العدو” آخذ في الازدياد (ص 51- 73). ما يقوله (ليفي) قديم بعض الشيء لأن سياسة نزع الصفة الإنسانية عن العرب تلازم الصهيونية من بداياتها كما تؤكد مئات الدراسات. أما المستوطنين فلم يشكلوا مجتمعا مدنيَّا أبداً، بل قوى شبه عسكرية فاشيّة تمهدّ الطريق أمام الجيش حتى باتوا يعرفون بـ”جيش الظلّ” الأمر الذي دفع وزير الصحة الإسرائيلي السابق، (يئير هيرفوفتش) إلى وصف ممارساتهم ضد العرب بالـ”مجازر/ “pogroms وبما أنهم يحظون بدعم مجتمعي، سياسي وإعلامي واسع. في السنوات الأخيرة وسّع المستعمرون نشاطهم إلى الأرض المحتلة 1948 بهدف طرد عرب يافا واللد والرملة وعكا. أما انفصال العنف العسكري عن المنطق السياسي فيمكن القول أنه منهج اليهود في “إدارة” الصراع اليهودي- العربي. كان (ليفي) قد قال عن فترة (كوخافي) التي انتهت مع تشكيل الحكومة السابعة والثلاثين للكيان، بأن (كوخافي) قد ترك جيشاً فتّاكاً وعمل على “تصنيع الإبادة” (https://telem.berl.org.il/6552/) وتشهد عليه عمليات إبادة الشباب في مخيمي جنين وبلاطة، وفي قصبة نابلس وحوارة، ومفارق الطرق ومحطات المواصلات العامة في الضفة الغربيّة، وتشجيع الجريمة في مناطق الـ48.
يبحث (دانييل بار- طال)، عالم النفس الاجتماعي والسياسي في المقال الثالث- “جوهر انعدام الأمن في إسرائيل” ويؤكد على الاستخدام المتلاعب الذي يقوم به القادة لتكثيف الشعور بالخوف لدى السكان الإسرائيليين و”لفهم التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل على أنها وجودية”. ويؤكد على أن “القادة الذين يسيطرون على دولة إسرائيل اليوم بالغوا بشكل كبير في الرسائل التي ينقلونها للجمهور” […] وهدفهم هو تثقيف الناس للسعي لتحقيق أهداف قصوى في الصراع “بصفتهم شركاء أشرار وغير موثوقين، كمحرضين ومربين لأبنائهم على كره اليهود” في حزبهم وأفكارهم (ص 75 -99). بات هذا الباب في إسرائيل يُعرف باستخدام التخويف في السياسة لشحن المستعمرين اليهود بعداء للعرب معالمه غير واضحة. بدأ (بن جوريون) بهذه السياسة وأبدع باستخدامها (نتنياهو). إلا أن هنالك فارقاً واضحاً بين الأول الذي كان يتسمّ “بالشجاعة” والثاني الذي يكنى بالجبن أو “جبان” كما وصفه أكثر من تقرير أمريكي. ويمكن القول أن التخويف من منطلق الجبْن وضع إسرائيل في مأزق استراتيجي، كما أعلن أكثر من ضابط في الاستخبارات العسكرية وخبراء الجيو- استراتيجة في الكيان لأن تحريض (نتنياهو) ضدّ إيران دفعها للتموضع على بعد عدة مئات من الأمتار على الحدود في الجولان السوري المحتل مع فلسطين المحتلة وفي قضاء غزة. فقد أشرت إلى عملية التخويف ذلك في مقالي هذا- (التخويف من العرب هو عصب الثقافة في «إسرائيل»، و«اليسار» أكثر عنصرية من «اليمين» 2015).
يؤكد (ريكي تيسلر) في المقال الرابع- “التربية المدنية كقاعدة للأمن الوطني- والعكس” على “أن الأمن الوطني لا يمكن فصله عن الأمن الداخلي (المرونة الوطنية) ، ولهذا فهو يحتاج إلى شروط عدّة مثل المساواة المدنية والانتماء والشراكة والثقة والسلطة السياسية والشرعية. واستخدام التوجيه؛ (متأثراً بأقلية أيديولوجية محددة) لتعليم المواطنة والتربية المدنية كأدوات سياسية لإدخال التلقين في التعليم الأيديولوجي القومي و”فرض التغيير في شخصية الدولة، من دولة يهودية وديمقراطية إلى دولة عرقية- حالة ثابتة” (ص 101- 136). في هذا المحور أو القاعدة فشلت إسرائيل بتحقيق المساواة والشراكة والثقة، ليس فقط مع العرب الموجودين فيها، بل مع مجموعات يهودية كبيرة مثل اليهود الشرقيين والأثيوبيين، وكبار السنّ والنساء والأطفال. ووفقاً لمعطيات مؤسسة التأمين الوطني لسنة 2020 بلغت نسبة الفقر بين السكان 21% وهذا يعني 2 مليون فرد منهم 900 ألف طفل، وهؤلاء لا يوجد من يمثلهم تمثيلاً فعليّا حيث تتحدث عنهم جمعيات يصرف أعضائها على العمل المكتبي أضعاف ما تقدمه لهم من مساعدات. كما خصصت الحكومة الحالية مبلغ 700 مليون شيكل ليقوم (آريه درعي) بتزويعه على شكل “قسائم غذاء” للعائلات اليهودية الفقيرة- كما هو مُرجح. وفي سياق انعدام الثقة يستحضر العديد من الكُتّاب اليهود الخلافات التي كانت دائرة بين اليهود (الحريديم) في أوروبا الشرقيّة و”العلمانيين” في أوروبا الغربيّة قبل 200 سنة، فيشيرون إلى أن أحد أسباب الخلاف الحالي يعود إلى ما قبل نشوء الكيان، وفشل بوتقة (بن جوريون) لصهر المستعمرين اليهود في هوية إسرائيلية جامعة. وقد جندوا لابراز هذا الخلاف رسالة كان قد أرسلها والد الأديب اليهودي- التشيكي، (فرانز كافكا، 1883- 1924) يُعيب فيها على ابنه مصادقة اليهود (الحريديم) من شرق أوروبا.
تبحث (هنرييت دهان- كَليف) في المقال الخامس- “غزو الجيش للقطاعات الأمنيّة” في تغلغل الضباط المتقاعدين في الجيش إلى المناصب الإدارية واستيعابهم في قطاعات التعليم والذي ينبع من اهتمامهم الوظيفي، أي بالوظائف. وهذا أيضاً يخلق “هيمنة عسكرية واقتصادية داخل المجال المدني” (ص 137- 159). بدأ غزو ضباط الجيش المتقاعدين للقطاعات المدنيّة في أواسط سبعينات القرن الماضي حيث تم تعيينهم إداريين في مصانع القطاع العام الكبير، وسرعان ما ساءت إدارتها فأفلس بعضها وخُصخص الآخر لسوء الإدارة كما أشار خبراء الإدارة في حينه. وفيما بعد تم فصل منصب مدير المدرسة الثانوية إلى منصبين، مدير تربوي ومدير إداري يشغله ضابط متقاعد. واليوم تعج المدارس الثانوية والجامعات والكليّات والأطر التعليمية والتربوية والإعلامية بضباط الجيش المتقاعدين. ينشر هؤلاء قيمهم الأمنيّة والعسكرية التي لا تنسجم بالضرورة مع المجتمع اليهودي الذي يخدم غالبية أفراده في الجيش، على حساب القيم المدنيّة.
في سياق سيطرة الأمني والعسكري على المدني تكتب (إفرات شلفي- لابوفيتش) في المقال السادس- “تطوّر صورة الجندي القتالي كتعبير للتغيّرات الجندرية في المجتمع الإسرائيلي وتمثليهم في “بَمِحَنيه/ [المعسكر]” على ضوء أهمية الشعور الوطني” وتقول أن صورة الجنود القتاليين على صفحات مجلة الجيش “بَمِحَنيه/ [المعسكر] تغيرت بين الأعوام 1948- 2009 “من صورة جندي قتالي إلى صورة جندي قتالي حسّاس، لتعود أثناء الحرب إلى صورة الجندي القتالي” بهدف تعزيز الإحساس بالأمن الوطني للجمهور الإسرائيلي”. ثم تضيف: “تفوّق الرجل القتالي يؤثر على صعوبة الحراك الاجتماعي للنساء في تبوؤهن وظائف مفتاحيّة، وعلى مكانتهن في المجتمع […]”. ثم تخلص بالقول إن استمرار النزعة الذكورية في الدولة تؤثر سلباً على الأمن المدني- الاجتماعي للنساء (ص 161- 182). يمكن القول إن مُجتمع المُستعمرين اليهود ذكوري بامتياز لأنه يعتمد على الرجال المحاربين، وأن النساء تؤدي الدور البارز بإعادة إنتاجه عندما يتوجه قطاع واسع منهن إلى الاخصاب المخبري بذكور- كما لاحظت بعض الممرضات العربيات العاملات في عيادات تخدم اليهود. كما أن النساء العازبات تفضل الزواج بأفراد قوى الجيش والأمن.
وفي سياق الصراع الجندري في الجيش والكيان، تكتب كلاً من (أييلت هرئيل- شليف) و(شير دفنا- تقوع) في المقال السابع- “عن البحث والإصغاء- حالة نساء مقاتلات في منطقة مواجهة” وتناقشان العلاقات الجندرية والمساواة بين المقاتلات والمقاتلين في الوحدات التي تضم الجنسين، وتخلصان إلى نتيجة بأن “أولئك النسوة موجودات في معركة مزدوجة- في محاولة استيعابهن في النظام العسكري الذكوري، والحرب ضد ‘العدو’ في المعركة” (ص 211- 226). تنتمي الباحثتان إلى تيّار عسكرة النسوّيّة في الكيان رغم معارضة القوى الدينية المختلفة والجيش الذي يعتبرهن عبئاً عليه. لكن، من أجل تحسين صورته المجتمعية، يقبل الجيش ببعض النساء ويسلطّ الضوء على “إنجازاتهن” بقتل العرب ومداهمة بيوتهم. إضافة إلى ما تقدم، وضمن محاولة إعادة توزيع الثروات المادية والسياسيّة، أدخلت مفاهيم قطاعات عسكريّة وأمنية، مثل الطيّارين والأمنيين من (الشباك) و(الموساد)، إلى الخطاب “الديموقراطي” القائل بأنهم يخدمون الدولة أكثر من (الحريديم) لذا يحقّ لهم الحصول على الحصة الكبرى من الثروات المتنازع عليها.
في المقال الثامن- “العلاقة بين الانتماء الثقافي والشعور بالأمان الشخصي” يحلل كلاً من مهند مصطفى وأيمن إغبارية عمليات اندماج المسلمين في البلدان التي يشكلون فيها أقلية ويؤكدان على القيود السياسية والدينية التي يواجهونها، بما في ذلك في إسرائيل. وتشمل هذه الصراعات “وصايا الإسلام ومتطلبات الاقتصاد والسياسة والتعليم والحياة اليومية للواقع غير الديني الذي يجد المؤمن المسلم نفسه فيه”. يستنتج المؤلفان أن “محاولات سن قوانين خاصة لم تكن تهدف إلى تسهيل اندماج المسلمين في مجتمع الأغلبية، بل على العكس من ذلك- سعت إلى فصل المسلمين عن المجتمع الإسرائيلي”. يقوم الباحثان ببحث الموضوع من خلال فقه الأقليات للمُسلمين في إسرائيل إلى جانب النضال المُشترك لعرب الأرض المحتلة سنة 1948 لتحقيق المساواة (ص 227- 245). مما تقدم نفهم أن الباحثين يعملان على تفكيك عرب فلسطين من شعب إلى أقليات دينية، من خلال نزعهم عنهم صفة الشعب الأصلي صاحب البلاد وتاريخها لصالح المقارنة مع المهاجرين المُسلمين في أوروبا. هذا العمل وإن كان بحثاً فكريّا لكنه يصبّ في صالح إسرائيل التي تتعامل مع العرب على أسس قانون “الملّة” العثماني. من هذا الباب تسللت الحركة الإسلامية الجنوبية، التي أسميتها بالإسلام الإسرائيلي قبل ثلاثة عقود لتنضم إلى أكثر حكومة يمينية في تاريخ الكيّان من أجل “التأثير” حيث شاركت باتخاذ قرارات سيئة للغاية على العرب في الكيان. وعلى قاعدة هذه الخلفية الفقهية تسربت الحركة الإسلامية الجنوبية إلى الحكومة السادسة والثلاثين للكيان التي تم تنصيبها في 14 حزيران 2021 حتى تنصيب الحكومة الحالية، السابعة والثلاثين.
تختم المحررتان الكتاب بالمقال التاسع- “اقضِ على الحرب خارج الوعي: الأخلاق والصدمة في عمل ليئه جولدبيرج” لـ(ليفين- حزان) بمناقشة مقال لـ(جولدبيرج) نشرته مع اندلاع الحرب العالميّة الثانية سنة 1939 لا يزال يثير جدلا واسعاً حول سؤال: هل يجب أن يصمت الفكر عندما تهدر المدافع؟ وما إذا كان يجب أن يكون الأدب صامتاً. ثم تجيب (جولدبيرج) بأن على الفكر أن يستمر بالتعامل مع كل المواضيع الإنسانية لتذكير الإنسان بأنه لا يزال يوجد في العالم نفس القيم البسيطة والأبدية التي تجعل الحياة أكثر قيمة (ص 247- 259) . هذه القضية كلاسيكية وقد تبنى جميع الذين طرحوها نفس موقف (جولدبيرج). لكن إذا ما فحصنا موقف الإعلام الإسرائيلي الذي يعبر عن موقف المجتمع اليهودي وقطاع واسع من نخبه نجد أن الأمر على النقيض، يكفي أن نفحص موقف هذا الإعلام في الحروب على غزة لنكتشف أن صانعيه كانوا يحرضون على مزيد من الجثث ليس في غزّة وحدها، وفي مناطق الـ48 حيث كانوا يحرضون على مجزرة، وقد لخصت هذا الموقف في مقال لي بعنوان (عن مجزرة محتملة- أتحدث!). وفي الحرب الأخيرة بأيّار الفائت، سنة 2023، توحدت جميع القوى، التي تختلف على توزيع مصادر الثروة، على العدوان على غزة، وتجلّى من هذا الموقف بوضوح أن أشدّ ‘المدافعين عن الديموقراطيّة’ هم الذين دفعوا لهذا العدوان وتنفيذه، أقصد الجيش، والمخابرات، والموساد.. ووسائل الإعلام المختلفة (إلا بعض الأقلام).
وفي نهاية عرضنا للكتاب، نجمل بما يلي: إن تعزيز الهويّة الدينية كجزء من الهوية الإسرائيلية والفضاء الأمني- العسكري على حساب المدني لم يعمل على تعزيز المَنَعَة بل العكس، بناءً على تقارير أعدها اللواء (بريك)، وهو قائد فيلق، وقائد الكليات العسكرية ومفوض سابق لشكاوى الجنود (لمدة عقد)، والذي يؤكد دائما على أن الجبهة الداخلية غير جاهزة لأية مواجهة مسلحة وسينهال على إسرائيل مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة إلا أنها لن تتمكن من الردّ عليها وعلى تداعياتها الديموغرافية والاجتماعية. من المتوقع أن يتجاوز- وفقاً لمعطيات رسمية- عدد السكان الذين يعيشون في وضع عدم آمان غذائي المليون، غالبيتهم من (الحريديم) العرب، أبناء الطوائف الشرقيّة، والمسنّين والأطفال. والأهم من هذا كلّه، هو ما يخص مصير عرب فلسطين، الذي بات اعتبارهم (جوييم) جزءاً من الخطاب السياسي الجديد بصورة علنيّة، ويتشدد قمعهم في كل فلسطين إلى درجة بات فيها استخدام نكبة ثانية ضدهم شرعي. وما الهجوم على قريّة حوّارة برعاية كافة أذرع السياسة والقمع في الكيّان مساء 26 شباط من هذا العام (2023) إلا بروفة كما يعتبرها المهاجمون. فالسيناريو الذي كتب عنه (يورام يافال) في (هآرتس 6. 10. 2022) الذي يقول فيه أن إسرائيل بحاجة إلى 400 باص، ومدينة خيام واحدة لطرد 200 ألف عربي “من إسرائيل” إلى المنطقة (ج) في الضفة الغربيّة ليس ببعيد، بل هو قيد التنفيذ الفعلي!
جملة أخيرة، يمكن القول إن ما يجري في الكيان بالسنوات الأخيرة الخمس، تحديداً منذ تشكيل الحكومة الحالية، يعتبر نتاج قانون القوميّة من سنة 2018.