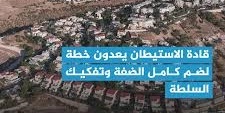مفارقة مؤسفة.. هكذا استطاعت الانظمة العربية المتسلطة تحويل شعوبها الأكثر تعلماً الى الأقل عملاً !!!

عادة ما تذكر معدلات البطالة عند مناقشة الاقتصاد، وعادة ما تذكر البطالة بوصفها سببًا من أسباب انتفاض الشباب العربي، ولكن البطالة لا تُحتسب عن طريق قسمة عدد غير العاملين على عدد السكان، بل عن طريق قسمة عدد غير العاملين ممن بحثوا عن عمل بشكل فاعل في الفترة الأخيرة، على إجمالي قوة العمل، والتي تتكون من العاملين وغير العاملين بالشرط المذكور.
بهذا التعريف التقني قد يقال إن العرب لم يكونوا يبحثون عن إيجاد الوظائف أصلًا، خصوصًا وأنَّ سبع دول عربية تتصدر قائمة أقل 10 دول من حيث نسبة المشاركة في قوة العمل على العالم، والبيانات واضحة في انخفاض معدل مشاركة العرب في قوة العمل، مقارنة بمناطق العالم الأخرى.
لا يقارب العالم العربي من المناطق إلا منطقة آسيا الجنوبية، والتي تضم كلًّا من أفغانستان، والهند، وباكستان، وسريلانكا، وبنجلاديش، وبوتان، والمالديف، ونيبال.
ولهذه البيانات محدداتها؛ فهي، وفق البنك الدولي نفسه، ضعيفة في قياس العمالة في الشركات الصغرى، أو العمالة في القطاع غير الرسمي، ولكن الفارق الكبير بين الوطن العربي وغيرها من المناطق، وخصوصًا المناطق التي تحتوي على قطاع غير رسمي واضح، ولذلك فحتى إن لم يكن ممكنًا الاعتماد على دقة البيانات، فإنه يكمن الاعتماد على الفارق بين المناطق المختلفة مؤشرًا.
ولا تتوقف المحددات عند ما ذكرناه؛ بل تتعداه لأمور أخرى كثيرة مثل تعريف العمالة، وسن العمل، وفترة البحث بشكل فعال عن عمل أو وجود هذه الفترة من الأساس، ودقة البيانات الرسمية، ودقة إجابات العمال عن استطلاعات الرأي المعتمدة في هذه البيانات. لكن ما يمكن التأكد منه هو أن مشكلة عمالة كبيرة متحققة بالفعل في الوطن العربي، وواجبة الفهم والتفسير والدراسة، خاصةً في سياق الحديث عن الربيع العربي.
تحالف النفط والسلطوية
يحاول الاقتصادي المصري رجوي أسعد في بحثه «فهم أسواق العمل العربية: الإرث الدائم للازدواجية» فهم سوق العمل العربي، فيبدأ بذكر خصائص مشتركة في الدول العربية؛ وهي قطاع عام متضخم، ومعدل بطالة مرتفع عند الشباب، وقطاع خاص ضعيف، ونمو الاستثمار في رأس المال البشري، مع كون هذا الاستثمار مشوهًا، وضعف مشاركة الإناث في سوق العمل.
يرى أسعد أن هذه المشكلات كلها إلى ظاهرة «ثنائية سوق العمل»، التي تحصل عندما يقسم سوق العمل لقطاعين؛ قطاع أساسي بمرتبات جيدة وظروف عمل ممتازة، ووظائف أخرى سيئة. ورغم أن هذه الظاهرة موجودة في غير العالم العربي، فإن أسعد يرى أنها كانت في العالم العربي بحجم كافٍ لتجعل سوق العمل العربي على ما هو عليه اليوم.
في حالة أمريكا نرى عوامل كثيرة تدفع باتجاه خلق هذا الانقسام والاستقطاب بين الوظائف الجيدة والوظائف السيئة، كما أن هذا الاستقطاب والانقسام يعمل ضمن ديناميكيات السوق، وهو خالق للواقع في أمريكا، لا أداة بيد نظام أو أنظمة بعينها لتشكيل الواقع السياسي والاجتماعي، أو لشراء الولاءات.
نقيضا لذلك، فإن الثنائية في سوق العمل العربي ليست ظاهرة اعتيادية يمكن مجابهتها بالحديث عن اللاعدالة واللامساواة الاقتصاديين بوصفهما ظاهرتين استثنائيتين (رغم أن ذلك محل نقاش حتى في حالة أمريكا)، ولكنها ظاهرة ناتجة من طبيعة الأنظمة السياسية العربية كما يقول أسعد.
يحصل ذلك عن طريق استخدام سوق العمل ضمن الواقع الاجتماعي بين الأنظمة العربية السلطوية والشعوب، بما يسمح باستمرار وجود هذه الأنظمة، ويمنع قيام الثورات ضدها، وفي الطريق إلى ذلك يعيد إنتاج مشكلات التنمية، ويؤجل الانفجار إلى حين آخر، عندما تختلف الظروف. أنتج هذا الواقع فئات مجتمعية تقوم عليها سلطة الأنظمة العربية سياسيًّا واجتماعيًّا، تعد الأكثر أهمية ودونها لا تستطيع الأنظمة العربية الاستمرار على ما هي عليه.
تقسيمات الدول العربية
يمكن تقسيم الدول العربية من حيث خصائصها إلى ما يلي: دول الخليج ذات عدد المواطنين المنخفض جدًّا، وهي قطر، والإمارات، والبحرين، والكويت. تملك هذه الدول نسب مشاركة عالية في سوق العمل، تتراوح بين قطر الأعلى في العالم بنسبة 87%، والكويت بنسبة 75%، وهي نسبة أعلى من نسبة الولايات المتحدة الأمريكية.
والتفسير لهذا بسيط جدًّا، فالنسبة لا تحتسب المواطنين وحدهم، بل تحسب معهم المغتربين العاملين. ومن جهة أخرى فإن هذه الدول تملك قطاعات عامة أضخم نسبيًّا من غيرها من الدول العربية، ومن ثم تستطيع توظيف المزيد من مواطنيها في وظائف أكثر راحة وضمانًا دون ربط بين الأداء والعائد المادي، وفي هذا تشتري الدولة ولاء المواطنين، ولديها فائض قوة اقتصادية للتعامل مع الخارج.
على النقيض من هذه الدول، الدول العربية ذات عدد السكان الكبير نسبيًّا، مثل السودان، ومصر، والمغرب، والجزائر، والعراق. وهذه الدول تتراوح النسبة فيها بين قرابة 50% في السودان، و44.7% في العراق، والمعادلة في هذه الدول أصعب وأكثر تعقيدًا، وتحتاج بحثًا كاملًا لكل دولة فيها على حدة.
ولكن بشكل عام؛ احتاجت هذه الدول لبناء قطاع عام مضخم يوظف ويخلق الطبقة الوسطى المتعلمة في البلاد، لتحالف بين السلطة والثروة، وقطاع عسكري وأمني متضخم؛ ينتج ذلك مستويات ثلاثة: رأسمالية متصدعة لا مكان فيها للشركات المتوسطة والصغيرة، والطبقة الوسطى هي صناعة شبه حصرية لموظفي الدولة والشركات الكبرى، نخبة متعلمة تخلق الخطاب الرسمي وتحاول السيطرة على المجتمع بالأساليب الناعمة، وتوسيع الحلف لأبعد مستوى دون استخدام المال، وبطش أمني يعوض ما تفقده هذه الأنظمة من الموارد بالعنف والمراقبة والسجون.
يلاحَظ أن النسبة في هذه الدول ترتفع وتنخفض تبعًا لمعادلات أخرى؛ هي ارتباطها بالأنظمة النفطية الخليجية، وتحصيلها على ريوع نفطية غير مباشرة عن طريق تصدير العمالة، وحجم عدد السكان والتكلفة اللازمة لتشغيلهم، ووجود موارد طبيعية لا تجعل هذه الدول في مصاف دول الخليج، ولكن في وضع قريب منها.
لذلك فإن مصر تعوض ضخامة عدد سكانها بمواردها من الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبتحويلات عامليها في الخليج ومصادر عملات أجنبية أخرى مثل السياحة. بينما يستطيع العراق التصرف لوفرة النفط فيه مع بقاء سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب، وهو ما ينطبق على سوريا بعد الثورة، بينما تكون دولة مثل الجزائر في المنتصف.
أما الفئة الثالثة فهي الدول العربية الصغيرة، ومنها الدول التي تعتمد تقسيمات فئوية طائفية أو عشائرية مثل الأردن، واليمن، ولبنان، وهي دول استفادت أكثر من غيرها من ريوع النفط غير المباشرة، عن طريق المغتربين في دول الخليج.
ويبقى من الدول العربية حالات خاصة واستثنائية؛ مثل السعودية التي تمتلك مصادر طبيعية كثيرة مع عدد مواطنين كبير، وليبيا التي تمتلك مصادر طبيعية أكبر نسبيًّا من غيرها من الدول العربية، وتشترك مع سوريا والعراق بواقع الحرب والانفلات الأمني والسياسي.
ويقدم أسعد حجة أن هذه الدول خلقت سوقًا فيها انقسام شديد بين وظيفة قطاع عام جيدة جدًّا، ووظائف أخرى إما معدومة أو سيئة جدًّا، مع كون الوظائف الجيدة كافية للإنفاق على أكثر من أصحابها المباشرين وحدهم، ومن ثم اضطرار الباقين إلى الاختيار بين الوظائف السيئة أو الاعتماد على دخل الآخرين، أو البحث عن عمل خارج البلاد، والأخير أحد أسباب ارتفاع معدلات العمل في دول الخليج التي تستقبل عمالة عربية من خارجها.
انفجار الواقع الاجتماعي
مر الواقع الاجتماعي العربي بضربات ونكسات متعلقة بأسعار النفط والترتيبات الإقليمية والدولية، وأخرى خاصة بدول بعينها، أول هذه الضربات المتعلقة بالمنطقة كاملها كانت انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات، والتي هددت استقرار الأنظمة سياسيًّا حينها لولا أن سقوط الاتحاد السوفيتي وبدء حرب الخليج، مددا من عمر النظام العربي الرسمي كما كنا نعرفه قبل عام 2011.
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2007 و2008، والهبوط النسبي لأسعار النفط على إثرها لفترة قصيرة، مع تزايد أعباء استمرار العقد القديم، وتزايد عدد السكان، وتضخم الدين، واستنزاف أصول الدول العربية، ومن ثم ارتفاع الفقر والبطالة، وعدم كفاية وظائف القطاع العام في الدول الأكثر سكانًا لضمان استمرار الوضع القائم، وتضافر هذه العوامل الاقتصادية مع غيرها من العوامل السياسية أدى نهايةً إلى ثورات الربيع العربي.
لكن الشعوب لم تستطع نهايةً إرساء واقع اجتماعي جديد، ولذلك فإن الواقع القديم ما زال موجودًا، مع انتفاء كثير من أسباب وجوده السابقة، وبانتظار موجة جديدة أو تغيير هذه الأنظمة لنفسها وإيجاد صيغ ومعادلات جديدة.
وحتى ذلك الحين لا تستطيع الشعوب العربية إنشاء قطاع خاص حقيقي يستطيع خلق فرص للتوظيف، وتحتكر الأنظمة ورجال الأعمال المتحالفين معها إمكانية العمل في السوق، مغلقين بذلك الباب على الناس لتشكيل أسواقهم عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل يفرض في ذلك ظروفًا اقتصادية تنهك كاهل مثل هذه المحاولات؛ مثل أسعار الفائدة المرتفعة جدًّا، والتي تمنع غير الشركات الكبرى من تحصيل رؤوس أموال عن طريق النظام المصرفي.
وعلى الجهة الأخرى تبقي الأنظمة العربية قبضتها على الدول ومؤسساتها؛ بما يمنع من خلق قطاعات عامة صحية، توزع فيها الوظائف وفق الكفاءة، وبما يفيد البلاد، بدلًا من معادلة الولاء.
لا يمكن تفسير مشكلة سوق العمل العربي ثقافيًّا
يمثل الكلام السابق محاولة لتفسير حالة سوق العمل العربية اقتصاديًّا وسياسيًّا، ولكن يمكننا أيضًا دحض بعض الافتراضات الخاطئة، والتي قد تحاول تفسير الوضع القائم في الدول العربية بغير التفسير السابق، ومعها نتكلم عن معضلة تشكل تناقضًا أساسيًّا بين مثل هذه السرديات التي تفصل الواقع السياسي عن واقع سوق العمل.
أشهر هذه التفسيرات هو التفسير الثقافي لمشكلة سوق العمل العربي، وتحديدًا مسألة وجود ثقافة غير مشجعة على العمل في الوطن العربي، وتحديدًا فيما يخص المرأة، والمبادرات والحملات المختلفة التي تقام عادة للتشجيع على ثقافة العمل وعمل المرأة، وتقبل ذلك وتسهيله في الوطن العربي.
لا يمكن أن ننفي وجود ثقافة غير داعمة في عالمنا العربي، ولكن دور الثقافة مضخم جدًّا في دولنا العربية، وإلا فكيف يمكن تفسير التناقض بين ارتفاع نسب تعلم المرأة والشعب العربي عامة ومعدلات العمل المتدنية عمومًا؟
يقدم بحث منشور على مجلة «البحوث الديموغرافية» لمجموعة من الباحثين تفسيرًا اقتصاديًّا وسياسيًّا مختلفًا للمشكلة، وذلك عن طريق دراسة حالة دول عربية أربعة، هي الأردن، ومصر، والجزائر، وتونس، منذ عام 2000. ويخلص البحث إلى أن انخفاض عمالة المرأة ناتج من الانكماش النسبي منذ ذلك الوقت في القطاع العام، وعدم نمو قطاع خاص بديل يكافئ الانكماش في القطاع العام.
ربما كانت الثقافة من عوامل تأخر دخول المرأة العربية لسوق العمل، ولكن نسب التعليم المتزايدة منذ عقود، مع بقاء نسب العمل ثابتة يعني أن المشكلة في جانب الطلب، مع عدم وجود فرص للرجال والنساء على حد سواء، فبقيت معدلات تشغيل النساء على ما هي عليه رغم ارتفاع عدد النساء الراغبات بالعمل.
لاحقًا يصيب الكثير من المتعلمين من الرجاء، والنساء اليأس من إمكانية إيجاد العمل، فيفقدون رغبتهم بالبحث عنه، أو يمتنعون عن المحاولة بسبب معرفتهم باستحالة إيجاد فرص عمل، خصوصًا مع ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية ضمن الوضع الحالي.
يساعد على ذلك كما تقدم قدرة الكثيرين على استنفاد مدخراتهم التي جمعوها خلال فترات رخاء سابق، أو الاعتماد على مصادر دخل خارجية من المساعدات إلى تحويلات العاملين في الخارج، والتي تصرف على كثيرين داخل بلدان العمال الأصلية، وما يتبقى تتكفل به الأجهزة الأمنية لإبقائه ضمن خانة الفقر والحاجة وعدم العصيان.
وتبقى الحقيقة واضحة، فالشباب الذين قدموا جهدًا ومالًا مقابل التعليم، ثم احتجوا في ثورات الربيع العربي طلبًا للعمل، لا يمكن أن يكون رافضًا للعمل بسبب الثقافة، والحديث عن الثقافة تورية للمشكلات الحقيقية في عالمنا العربي.