اصدار جديد .. فلسفات الأمس واليوم
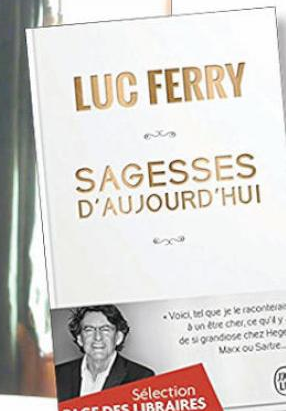
تحت عنوان «فلسفات الأمس واليوم» اصدر الفيلسوف الفرنسي لوك فيري كتاباً جديداً يستعرض تاريخ الفلسفة منذ اليونان حتى يومنا هذا، ولكنه يضيف إليهم غلغامش وبوذا وحكمة الشرق أو حكمائه. وينبغي أن نعترف فوراً بأن لوك فيري هو أفضل شارح لتاريخ الفلسفة في فرنسا، وربما في العالم كله. ما عدا ذلك، فإن هذا الكتاب يتحدث لنا عن تاريخ الفلسفة من هوميروس إلى أفلاطون، في فصل افتتاحي تدشيني، ثم ينتقل مباشرة لكي يتحدث عن أرسطو (تلميذ أفلاطون)، في فصل مطول يحاذي الأربعين صفحة تقريباً، يليه فصل عن الرواقيين، ثم عن الأبيقوريين، ثم عن غلغامش وبوذا وحكمة الشرق.
وبعدئذ، يكرس المؤلف فصلاً كاملاً ليسوع المسيح والثورة الدينية الرائعة التي دشنها ودفع حياته ثمناً لها. ولكن ينبغي الاعتراف بأن الدوغمائية الدينية الانغلاقية انقلبت لاحقاً على الفلسفة اليونانية، بل وكفرتها باعتبار أنها وثنية، ثم جاء عصر النهضة في القرن السادس عشر لكي ينقلب بدوره على الدوغمائية الدينية اللاهوتية، وينتقم للفلسفة. وهكذا، انتقلنا من نقيض إلى نقيض في تاريخ الفكر الأوروبي. فالعدو أصبح العصور الوسطى المسيحية، وليس الفلسفة والآداب اليونانية – الرومانية التي أشعلت النهضة الأوروبية. ومعلوم أن العرب لعبوا دوراً كبيراً في انطلاقة نهضة أوروبا، عن طريق نقل الفلسفة اليونانية إليها من خلال الفارابي وابن سينا، ثم الشارح الأكبر ابن رشد.
ونلاحظ أن لوك فيري يركز على شخصية واحدة من شخصيات النهضة الإيطالية، ألا وهو: بيك الميراندولي، الذي كان معجباً جداً بالعرب وحضارتهم وثقافتهم. وسوف أتوقف عنده لحظة بعد قليل. وماذا حصل بعد عصر النهضة في القرن السادس عشر؟ شيئان عظيمان: الثورة العلمية التي قضت على علم أرسطو وبطليموس، بفضل كوبرنيكوس وغاليليو، والثورة الفلسفية التي تحققت على يد ديكارت.
وبعد أن يفرغ المؤلف من الحديث عن الثورة الديكارتية، نجده يكرس فصلاً مطولاً لأهم تلميذين خرجا من معطف ديكارت وتفوقا عليه في بعض المجالات، وهما لايبنتز وسبينوزا. ثم يخصص صاحبنا فصلاً كاملاً للفلسفة الأنغلو – ساكسونية، وهذا أضعف الإيمان. وبعدئذ، ينتقل مباشرة إلى التحدث عن كانط والأنوار. ومعلوم أن فيري مختص بكانط، وهو يقرأه في النص الأصلي، أي الألماني. بل ونعته البعض بأنه كانط جديد، عندما اندلعت المعركة ضد فوكو ونيتشه في الساحة الباريسية نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. ثم يخصص المؤلف فصلاً كاملاً لجان جاك روسو وتوكفيل، اللذين دشنا الفكرة الديمقراطية في الغرب. وبعدئذ، يخصص فصلاً طويلاً لهيغل والفلسفة المثالية الألمانية، ثم ينتقل إلى شوبنهاور العدو اللدود لهيغل. ومعلوم أنه كان يغار منه، ويشتمه بعبارات نابية. وبالتالي، فالفلاسفة الكبار قد يفقدون أعصابهم أحياناً بسبب الغيرة والحسد من بعضهم بعضاً، وكنا نتوقع منهم غير ذلك، ولكن انظر إلى حقد المثقفين العرب على بعضهم بعضاً أيضاً! ثم ينتقل المؤلف إلى تلميذ شوبنهاور الذي تفوق على أستاذه: عنيت نيتشه. وبعد نيتشه، يجيء دور ماركس وفرويد وكارل بوبر وهيدغر، وسارتر والفلسفة الوجودية، ثم فكر «مايو 68»، المتمثل بالأقطاب الكبار فوكو وديلوز ودريدا، إلخ. وهم الذين حاول لوك فيري تفكيكهم أو تحطيمهم في كتاب مشهور صدر بالاسم نفسه عام 1985. ثم يختتم المؤلف كتابه بفصل مطول عن وضع الفلسفة اليوم. هكذا، تلاحظون أني عددت مفاصل الكتاب بدقة لكي يتسنى للقارئ أخذ فكرة عن المشروع العام ككل. والآن، دعونا ندخل في التفاصيل.
يرى المؤلف منذ البداية أن هدف الفلسفة هو: تحديد نوعية الحياة الجيدة التي ينبغي أن يعيشها الإنسان؛ إنها تبغي التوصل إلى الحكمة التي تقودنا في الحياة، وذلك اعتماداً على العقل فقط. والفلسفات المتتالية ما هي في نظر لوك فيري إلا روحانيات علمانية منافسة للدين، أو مستغنية عنه، وذلك على عكس الروحانيات الدينية التي لم يعد لها لزوم في عصر الحداثة، بحسب رأيه. وهنا، نجد أنفسنا مختلفين مع السيد فيري، فنحن لا نعتقد أن بتر الإيمان أو الدين شيء مستحب. نعم لبتر التعصب الديني التكفيري، ولكن لا لبتر الدين في المطلق، فنحن لا نعتقد أن هناك تعارضاً بين الفلسفة والدين، أو العقل والإيمان، بشرط أن نفهم الدين بشكل عقلاني متنور. وأكبر مثال على ذلك الفيلسوف بول ريكور، فقد كان فيلسوفاً ضخماً، باعتراف لوك فيري نفسه، وفي الوقت ذاته كان مؤمناً كبيراً. على أي حال، فالسيد فيري حر في تصوراته، مثلما نحن أحرار في تصوراتنا.
لكن لنواصل رحلتنا مع هذا الكتاب الضخم الذي يتجاوز الثمانمائة صفحة من القطع الكبير.. يرى المؤلف أن الانتقال من مرحلة هوميروس إلى مرحلة أفلاطون يعني الانتقال من عصر الأسطورة إلى عصر الفلسفة، أو من عصر الملاحم الشعرية إلى عصر النثر والعقل. بهذا المعنى، فإن أفلاطون هو أول فيلسوف في تاريخ البشرية، وربما أكبر فيلسوف، كما قال لي يوماً ما كاستورياديس، أستاذ لوك فيري نفسه وكل جيله، وذلك عندما قابلته يوماً ما في منزله الباريسي لصالح مجلة «الكرمل»، التي كان يرأس تحريرها شاعرنا الكبير محمود درويش.
وماذا عن أرسطو الذي هيمن على البشرية العربية الإسلامية والأوروبية المسيحية طيلة العصور الوسطى؟ إنه القطب المضاد لأستاذه أفلاطون. فبقدر ما كان هذا الأخير مثالياً سارحاً في عالم المثل السماوية، كان أرسطو واقعياً يركز اهتمامه بالدرجة الأولى على دراسة الواقع الأرضي المحسوس. والصراع بين أفلاطون وأرسطو اخترق تاريخ الفلسفة من أوله إلى آخره، إنه الصراع بين المثالية والواقعية. نقول ذلك باختصار شديد وتسرع أشد. والآن، لنقفز على فصول كثيرة، ولننتقل مباشرة إلى عصر النهضة في القرن السادس عشر. وهنا، نصل إلى بيك الميراندولي، الذي يُعتقد أنه مات مسموماً في عز الشباب: 31 سنة فقط! لقد اغتاله الإخوان المسيحيون، فقد اتهموه بالزندقة والكفر والخروج على الدين. وكان الميراندولي يقول إن علينا أن نقلد علماء العرب وفلاسفتهم، إذا ما أردنا أن ننهض ونتطور. وكان في رأي لوك فيري أول من بلور النزعة الإنسانية الحديثة في الغرب، عندما ألف كتابه عن «الكرامة الإنسانية أو العظمة الإنسانية»، ولذلك اصطدم باللاهوت المسيحي ورجال الدين، وقد اشتهر بثقته الكبيرة في الإنسان، وقدرته على صنع المعجزات، وقال إنه أخذ هذه الفكرة عن كتب العرب التي تقول إنه «لا يوجد على وجه الأرض أروع من الإنسان»، ولكن المتشددين فهموا كلامه على أساس أنه تطاول على الذات الإلهية. هذا في حين أنه كان مؤمناً بالله، ولا غبار عليه، ولكن الإنسان في نظرهم لا يستحق كل هذا الاهتمام والتمجيد، فهو مجرد عابر فان، يجدر به أن يفكر بآخرته لا بدنياه. وهنا، نلتقي بإحدى سمات العصور الوسطى التي كانت تحتقر الحياة الدنيا، وتزهد بالإنسان وإمكانياته وملكاته وقدراته.
ننتقل الآن بسرعة شديدة إلى ديكارت، الذي يقول عنه المؤلف: لقد خُلد اسم ديكارت لاحقاً عن طريق كتابين فقط، هما: مقال في المنهج (1637)، والتأملات الميتافيزيقية (1641). وهذان الكتابان صغيران من حيث الحجم، ولكنهما ضخمان من حيث التأثير الذي مارساه على تاريخ الفلسفة، والدليل على ذلك أن العمالقة اللاحقين، من هيغل إلى هيدغر، أشادوا بديكارت كل الإشادة، واعتبروه بطل الفكر والمؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة، بمعنى أنه أغلق العصور الوسطى والفلسفة الأرسطوطاليسية. ولا نستطيع الدخول في تفاصيل الفلسفة الديكارتية لأننا قد نغطس بكل بساطة. ولن نتوقف عند تلميذيه الكبيرين، لايبنتز وسبينوزا، ولا حتى عند الفلسفة الأنغلو – ساكسونية، وإنما سننط نطة كبيرة واحدة لكي نصل إلى كانط والأنوار، فماذا يقول لوك فيري عن الموضوع؟ يقول بالحرف الواحد: «سوف نتحدث اليوم عن إيمانويل كانط (1724 – 1804)، إنه أكبر فلاسفة التنوير وأعظمهم شأناً، وربما كان أكبر فيلسوف في تاريخ البشرية. إن مؤلفاته تشبه جبال الهمالايا: من الصعب جداً تسلقها، ومن المستحيل مضاهاتها». ولكي لا نغطس هنا أيضاً، بل ونغرق كلياً، دعونا ننتقل فوراً إلى الفصل التالي، عن جان جاك روسو، أستاذ كانط ذاته ومثله الأعلى، قدوةً وأخلاقاً وسلوكاً.
أين تكمن عظمة روسو؟ في نزعته الإنسانية العميقة التي لا تضاهى. يضاف إلى ذلك أن روسو غامر بحياته من أجل الحقيقة؛ لقد شطب على حياته الشخصية بكل بساطة. ما السؤال الرئيسي الذي طرحه جان جاك روسو على عصره؟ إنه التالي: هل التقدم العلمي والتكنولوجي للبشرية يترافق بالضرورة مع التقدم الأخلاقي والإنساني؟ سؤال هائل وعظيم انفجر في عصره كالزلزال أو البركان، فراحوا يشتمونه ويتهكمون عليه، بل ويطلقون الشائعات حول مدى صحته النفسية وإمكانياته العقلية.

